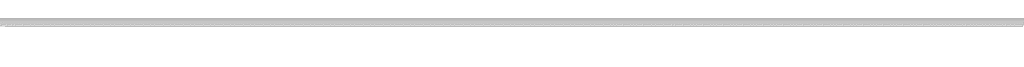د. عبد الرحمان إكيدر
ملخص البحث:
نسعى في هذه الدراسة إلى كشف ما تختزنه نصوص عبد القاهر الجرجاني من أفكار ودلالات تشي باستحضار النص باعتباره بنية للتحليل تتجاوز حدود المفردات والجمل، وتبرز أهمية السياق الكلي الذي تتعدد فيه هذه الجمل وتترابط وفق قوانين، وذلك من خلال التركيز على مفهوم “التعليق” الذي يعد محور نظرية النظم. فقد استأثر هذا المفهوم باهتمام عدد من الباحثين المحدثين وفي مقدمتهم؛ تمام حسان ومحمد حماسة عبد اللطيف ومصطفى حميدة وأحمد العلوي وغيرهم، حيث تشير آراؤهم إلى البحث في ماهية “التعليق” عند الجرجاني، وبيان دوره في عقد التركيب وتوثيق أواصره. وعليه، فسيكون التركيز في هذا الصدد منصبا على محاولة الإجابة عن السؤالين الآتيين: ما مفهوم “التعليق” عند عبد القاهر الجرجاني؟ وكيف تلقى الباحثون العرب المحدثون هذا المفهوم؟
الكلمات المفتاحية: التعليق – النظم – المعنى – التلقي – الفكر اللغوي والبلاغي.
The reception of the concept of “Relevance” by Abdul Qahir al-Jurjani In modern linguistic and rhetorical thought
Dr. Abderrahmane Iguider
Abstract:
In this study, we aim to reveal the ideas and meanings contained in Abdul Qaher Al-Jurjani’s texts, which indicate the evocation of the text as a structure for analysis that goes beyond the limits of vocabulary and sentences, and highlights the importance of the overall context in which these sentences are multiple and interconnected according to laws, by focusing on the concept of “relevance“, which is the axis of the theory of Alnadm. This concept has attracted the attention of a number of modern researchers, most notably; Tamam Hassan, Muhammad Hamasa Abdul Latif, Mustafa Hamida, Ahmed Al-Alawi, and others, as their opinions indicate research into the nature of “relevance” according to Al-Jurjani.
Accordingly, the focus in this regard will be on trying to answer the following two questions: What is the concept of “relevance” according to Abdul Qaher Al-Jurjani? And how did modern Arab researchers receive this concept?
Keywords: relevance – Alnadm – meaning – reception – linguistic and rhetorical thought.
مقدمة:
اتجهت العديد من الدراسات العربية الحديثة إلى دراسة المنجز اللغوي والبلاغي في التراث العربي من زوايا تحليلية عدة، رامية إلى الكشف عن حداثة ذلك المنجز؛ فقد أعادت بعض هذه الدراسات قراءة نصوص هذا التراث من منظور لغوي وبلاغي حديث، فتراوحت بين إقرار وجود وعي مبكر بطرق اشتغال اللغة والانتباه إلى البعد التواصلي والتداولي في تحليلات النحاة والبلاغيين والنقاد العرب، أو نفي هذا الوعي، وبين دعوة إلى مزيد من البحث من أجل استكشاف هذا التراث والبوح بمكنوناته وأسراره.
ومن هذا المنطلق، نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى كشف ما تختزنه نصوص عبد القاهر الجرجاني (ت. 471 هـ) من نظرات نافذة وأبعاد ودلالات تشي باستحضار النص باعتباره بنية للتحليل تتجاوز حدود المفردات وحدود الجملة الواحدة، وتبرز أهمية السياق الكلي الذي تتعدد فيه الجمل وتترابط وفق سنن وقوانين آخذ بعضها برقاب بعض، وذلك من خلال التركيز على مفهوم لم ينل ما يستحقه من العناية الكافية من قبل الباحثين، فقد كانت الإشارة لمفهوم “التعليق” إشارة عابرة ضمن دراستهم لنظرية النظم، خالية من التعمق في جذور هذه الفكرة واستدراج خباياها المتحجبة من مكامنها. فقد استأثر هذا المفهوم باهتمام الباحثين المحدثين وفي مقدمتهم؛ تمام حسان ومحمد حماسة عبد اللطيف ومصطفى حميدة وأحمد العلوي وغيرهم، حيث تشير آراؤهم إلى البحث في ماهية “التعليق” عند الجرجاني، وبيان دوره في عقد التركيب وتوثيق الأواصر بين عناصر الجملة.
نتغيا إذن، من خلال هذه الورقة البحثية تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: إعادة قراءة التراث اللغوي والبلاغي لصاحب الدلائل والأسرار واستقصاء مفاهيمه، والوصول إلى رؤية منهجية وشمولية لمفهوم “التعليق” وبيان امتداداته في الفكر اللغوي الحديث، خصوصا وأن تمام حسان (ت. 2011 م) اعتبر هذا المفهوم أخطر شيء تكلم فيه عبد القاهر على الإطلاق. وعليه، فسيكون التركيز في هذا الصدد منصبا على محاولة الإجابة عن السؤالين الآتيين: ما مفهوم “التعليق” عند عبد القاهر الجرجاني؟ وكيف تلقى الباحثون العرب المحدثون هذا المفهوم؟
مفهوم “التعليق” عند عبد القاهر الجرجاني.
ينطلق تحديدنا لمفهوم “التعليق” عند عبد القاهر الجرجاني من البحث عن المستويات المعرفية التي اعتمدها لبناء هذا المفهوم، فقد صاغ فكرة “التعليق” متأثرا بومضات سابقيه، وما خلفوه من أفكار في علوم النحو والبلاغة والكلام. وهذا ما أهله لبلورة هذه الفكرة في إطار نظريته في النظم. إن البحث عن جذور هذه الفكرة عنده لا يمكن فصله عن السياق العقدي والكلامي، فالبلاغة العربية نشأت في مجامع أهل الكلام وفي حلقات المناظرة والجدل حول عدد من القضايا مثل خلق القرآن وبيان إعجازه، وهذا أساس الخلاف الذي احتد بين المعتزلة والأشاعرة، فالفرقة الأولى نفت عن الله صفة الكلام، وأن يكون متكلما، منطلقين من فكرة راسخة لديهم هي نفي الصفات عن الله تعالى حرصا على تنزيهه عن أية مشابهة أو تصوير، ومعتبرين القرآن محدثا ومخلوقا، فيكون الكلام عندهم كائنا حسيا مكونا من أصوات وحروف منظومة. في حين يقول الأشاعرة بقِدَمِ القرآن، والمراد بالقديم هو الكلام النفسي القائم بذات الله، فكلام الله قديم من حيث معانيه، محدث من حيث ألفاظه المتصلة بالبشر المخلوقين. لقد اشتد الخلاف بين الفريقين منذ القرن الهجري الثاني ليصل ذروته في القرن الهجري الخامس، إذ كان عبد القاهر طرفا في هذا الجدل متكلما أشعريا، انطلق في إثبات الإعجاز القرآني من نسق لا ينفصل عن انتمائه للمذهب الأشعري، ويظهر ذلك جليا في ثنايا كتاباته، موجها سهام النقد إلى رؤوس المعتزلة الذين أرجعوا مسألة الإعجاز إلى الصرفة أو إلى نظم الألفاظ.
وانتقل هذا الجدل إلى الحقل اللغوي، فذهب الأشاعرة إلى تأكيد حقيقة مفادها أن اللغة ليست مجموعة من الأصوات أو الألفاظ كما يتصورها المعتزلة، بل هي نظام من العلاقات بين هذه الألفاظ يتعلق معاني بعضها ببعض من خلال مجموعة من الروابط التي تنشأ بين المفردات، ومن خلال هذه العلاقات تتم الفائدة. لقد كان اهتمام الجرجاني منصبا على الاعتناء بالمتكلم وما يدور في نفسه، يقول: “فإنَّ الاعتبارَ يَنبغي أن يكونَ بحالِ الواضعِ للكلامِ والمؤلِّف له، والواجِبُ أن يُنظرَ إِلى حالِ المعاني معه لا مَعَ السامِع”
([1])، أي بعملية إنتاج الكلام عند المتكلم، ويستند في ذلك إلى مقولات المذهب الأشعري. فقد “قادته فكرة الكلام النفسي ذاتها إلى فكرة النظم وهو نظم المعاني في النفس. وبالوصول إلى هذا التصور للنظم أصبح لزاما على عبد القاهر أن يقدم تفسيرا لعملية إنتاج الكلام، وهكذا وصل إلى إطار مكون من الأفكار الأربع «النظم» و«البناء» و«الترتيب» و«التعليق»”([2]). وعلى هذا الأصل بنى نظريته المعتمدة على دور المتكلم وما يجري من عمليات ذهنية نفسية في عقله، أبرزها عملية “التعليق”، ويظهر ذلك جليا في عدد من الجمل والعبارات المثبتة في (دلائل الإعجاز)، والتي تشير للفكر والنفس والعقل، كقوله:
- “الغرض بنظم الكلم (…) أن تناسقت دِلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل“([3]).
- “وإذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها…”([4]).
إنها إشارات إلى تلك العمليات الذهنية التي يجريها المتكلم في عقله بدءا بالنظم والبناء والترتيب وانتهاء بالتعليق. وهي مراحل نفسية معقدة لا يمكن الكشف عنها بسهولة، والفصل بينها ليس فصلا تاما قاطعا، والمتكلم يقوم بتلك الأنشطة في ومضة خاطفة.
وإذا كان النحاة قد اهتموا بمتلقي النص واتجهوا إلى دراسة الحصيلة النهائية لعملية التكلم أي الكلام المنطوق وما يصاحبه من إعراب، فإن عمل الجرجاني اتجه إلى دراسة دور منتج النص وما يدور في خاطر هذا المتكلم من كلام نفسي، منطلقا في ذلك من توجهه الكلامي. وهذا ما دعاه إلى التفكير في “التعليق” باعتباره عملية نفسية لغوية خاصة بالمتكلم، ويشير مصطفى حميدة إلى أن انطلاق صاحب نظرية النظم من قضية الإعجاز وما صاحبها من فكرة الكلام النفسي، “هو الذي وجه دراسته الوجهة الصحيحة التي خرج منها بنظرية (التعليق)، ذلك أن القرآن الكريم إعجاز للمتكلم لا للمتلقي، فجعل ذلك عبد القاهر يولي المتكلم عنايته، ثم قادته فكرة الكلام النفسي إلى فكرة نظم المعاني في النفس، وهي التي تعد من أحدث القضايا التي تشغل علم اللغة الحديث اليوم وأهمها”([5]). وهذا يبرز مدى ارتباط عملية “التعليق” بالكلام النفسي عند المتكلم الذي يقوم بصياغة معاني الألفاظ في ذهنه، وهو أمر يستدعي منا البحث عن دور “التعليق” وموقعه في عملية إنتاج الكلام.
إن مفهوم “التعليق” عند الجرجاني يرتبط بنظريته في النظم، فقد جعل هذا المفهومَ محورَ هذه النظرية وعمادها الرئيس، وتظهر قوة هذا المفهوم في ربط تحديده بماهية النظم، ومن تجلياته في “الدلائل”، قوله:
– “معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض”([6]).
– “(…) أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، ويُبنى بعضها على بعض، وتُجعل هذه بسبب من تلك”([7]).
وقد ورد هذا المصطلح مترددا بقوة في كتاباته بمختلف اشتقاقاته (تَعْلِيقٌ، تَعَلُّقٌ، عَلَّقَ، مُتَعَلِّقٌ، المُتَعَلَّقَيْن، تَعَلَّقَتْ، يَتَعَلَّقُ …)، وبنسب متفاوتة: (122) مرة في كتاب (المقتصد في شرح رسالة الإيضاح)، و(14) مرة في (أسرار البلاغة)، و(47) مرة في (دلائل الإعجاز). ففي الكتاب الأول نجد هذا المفهوم يحمل معنى نحويا محضا، خصوصا إذا استحضرنا أن كتاب (المقتصد) كتاب في علم النحو وشرح لأبوابه. يقول مصطفى حميدة “إن القارئ لكتاب (المقتصد) لعبد القاهريرى فيه إرهاصات تنبئ عن ميلاد وشيك لنظرية جديدة، لكنها لم تكن قد نضجت بعد. وأظن ظنا قويا أن عبد القاهر قد وضع ذلك الكتاب قبل [دلائل الإعجاز] (…) ويبدو لي أن عبد القاهر لو كان استقصى هذه الفكرة، وتتبعها في (المقتصد) حتى مداها، لأوصلته إلى نتيجتها المحتومة، وهي فكرة {التعليق}”([8]).
أما في كتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) فقد ارتبط مفهوم “التعليق” فيهما أساسا بنظرية النظم، وخصوصا الكتاب الثاني الذي أرسى فيه معالم المفهوم وطرقه بشكل واضح وبارز، حيث يتخذ “التعليق” بعدين متكاملين؛ البعد الأول نحوي وهو ما ارتبط بطرق تعلق الكلم، والبعد الثاني معنوي يتمثل في العلاقات الدلالية بين الألفاظ والجمل. والملاحظ أن صاحب الدلائل صاغ هذا المفهوم من خلال نصوص متناثرة ومتفرقة في ثنايا هذه الكتابات، حيث ربط مفهوم “التعليق” بدور المتكلم ومراعاته للجوانب المعنوية والدلالية. ومن النصوص التي نعتبرها مفتاحا لفهم ما قصده بهذا المفهوم، قوله: “ليس من عاقل يفتح عين قلبه، إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى في «ضم بعضها إلى بعض»، تعليقُ بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، لا أن يُنطق بعضها في أثر بعض، من غير أن يكون فيما بينها تعلق، ويعلمُ كذلك ضرورةً إذا فكر، أن التعلق يكون فيما بين معانيها، لا فيما بين أنفُسها، ألا ترى أنا لو جهدنا كل الجهد أن نتصور تعلقا فيما بين لفظين لا معنى تحتهما، لم نتصور؟”([9]).
فالمقصود ب”التعليق” ضم الكلم بعضها إلى بعض وفق ضوابط وقوانين معينة تجعل اللفظين المضمومين أو الألفاظ المضمومة متعالقة فيما بينها ومتماسكة من خلال علاقات لفظية ومعنوية، فتكون هذه بسبب من تلك. ويؤكد الجرجاني في أكثر من موضع أن “التعليق” يكون بين معاني الألفاظ لا بين الألفاظ أنفسها، فهو “نظم يُعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو [النظم] الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق”([10]). فإن كان نظم الكلم صحيحا فذلك يعود لصحة التعلق، والعكس أيضا صحيح، واستقامة الكلام رهينة بهذه العملية. فالكلمات تتلازم وتترابط وفق ما يقتضيه العقل ودرجة المقبولية بهدف الإفادة وحصول المعنى والقصد. ويشير إلى ذلك بقوله: “وليت شعري، كيف يُتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى «القصد إلى معاني الكلم»، أن تعلم السامع بها شيئا لا يعلمه. ومعلوم أنك، أيها المتكلم، لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تكلمه بها، فلا تقول: «خرج زيد»، لتعلمه معنى «خرج» في اللغة، ومعنى «زيد». كيف؟ ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف. ولهذا لم يكن الفعل وحده من دون الاسم، ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل كلاما. وكنت لو قلت: «خرج» ولم تأت باسم، ولا قدرت فيه ضمير الشيء، أو قلت: «زيد»، ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تُضمره في نفسك، كان ذلك وصوتا تصوته سواء”([11]).
إن إيصال قصد المتكلم إلى أذهان المخاطبين لا يتسنى إلا من خلال تعليق معنى كلمة بمعنى كلمة أخرى، ومن خلال هذا التعليق يتحدد المعنى وتتضح الرسالة المراد تبليغها، فالفعل (خرج) يستلزم كلمة أخرى (فاعل) قد يكون ظاهرا كزيد أو ضميرا متصلا (خرجتُ) أو ضميرا مستترا (اخرج) تقديره أنت، وهو تركيب دال ويحسن السكوت عليه، وإن كان في ظاهره يتكون من كلمة واحدة، والاسم كذلك وجب أن يتعلق باسم آخر (زيد قائم) أو أن يتعلق بفعل (زيد خرج). وتبعا لما سبق يرى الجرجاني أن دراسة الألفاظ في حد ذاتها لا تمثل شيئا في فهم النص، بل إن الفهم لا يتمثل إلا في العلاقات التركيبية، وليس بالكلمة المفردة والمجردة عن معاني النحو، وهو أمر يتنافى مع طبيعة الفكر والعادات الكلامية بين البشر ومع الأعراف اللغوية، ف”معلوم أن الفكر من الإنسان يكون في أن يخبر عن شيء بشيء، أو يصف شيئا بشيء، أو يضيف شيئا إلى شيء، أو يشرك شيئا في حكم شيء، أو يخرج شيئا من حكم قد سبق منه لشيء، أو يجعل وجود شيء شرطا في وجود شيء، وعلى هذا السبيل”([12]).
ف”التعليق”، إذن، ينشأ عن طريق إعمال الفكر وتضافره مع معاني الألفاظ والمعاني النحوية في سياق محدد مع مراعاة قوانين لغوية تكفل لتلك الألفاظ الانتظام في جمل تنتظم بدورها في نص يكتسب معناه من خلال توال لعمليات “التعليق”، حيث تتراص الألفاظ تراصا محكم التماسك لتشيّد بذلك صرحا نصيا، ف”لو كانت الألفاظ يتعلق بعضها ببعض من حيث هي ألفاظ، ومع اطّراح النظر في معانيها، لأدى ذلك إلى أن يكون الناس حين ضحكوا مما يصنعه المُجَّانُ من قراءة أنصاف الكتب، ضحكوا عن جهالة، وأن يكون أبو تمام قد أخطأ حين قال:
عَذَلًا شَبِيهًا بِالجُنُونِ كَأَنَّمَا قَرَأَتْ بِهِ الوَرْهَاءُ شَطْرَ كِتَابِ([13]) (بحر الكامل)
لأنهم لم يضحكوا إلا من عدم التعلق، ولم يجعله أبو تمام جنونا إلا لذلك”([14]).
لقد بنى الجرجاني مقولاته البلاغية على منطلقات نظرية تتمثل في كون هذه المعاني والصور البلاغية لا تحصل إلا عن طريق “التعليق”، أي تعليق معاني الألفاظ فيما بينها حيث تكتسب قيمتها الفنية والأسلوبية، معتبرا أن لا قيمة للفظ في حد ذاته معزولا عن سياقه، وبذلك حدد موجب الفصاحة والبلاغة، يقول: “وجملة الأمر أنّا لا نوجب «الفصاحة» للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقا معناها بمعنى ما يليها”([15]). وفي نص آخر، يقول: “وإذا كان كل واحد منهم قد أعطى يده بأن الفصاحة لا تكون في الكلم أفرادا، وأنها إنما تكون إذا ضم بعضها إلى بعض، وكان يكون المراد بضم بعضها إلى بعض، تعليق معانيها بعضها ببعض (…)”([16]). فلا يمكن أن نتحدث عن فصاحة دون تعليق معاني الألفاظ، فيكون بذلك التعليق النحوي محددا وموجبا للفصاحة، والألفاظ ليست إلا أصولا للمعاني، ولن يصبح لها معنى حقيقي إلا من خلال عملية “التعليق” والتصرف بأقسام الكلام التي تتجلى بها غايات المتكلم في المعاني التي ينشدها.
وبذلك يكون الجرجاني قد أرسى مبادئ علم المعاني الذي يبحث في تراكيب الكلام ودقيق المعاني وما يعتريها من فروق ووجوه، وأعطى صورة مطابقة لما في نفس المتكلم، فكانت مباحث هذا العلم تدور حول الخبر، والتقديم والتأخير، والوصل والفصل، والقصر، والإيجاز والإطناب … إلخ.
مفهوم “التعليق” عند الباحثين العرب المُحْدَثِين.
لقد شغل مفهوم “التعليق” اهتمام المحدثين في الدرس اللساني، فتعددت آراؤهم وقراءاتهم لنصوص الدلائل والأسرار. وقد تطرق تمام حسان لمفهوم التعليق انطلاقا من تصوره لعملية إنتاج الكلام. إذ نجده ربط في مقدمة ترجمته لكتاب (النص والخطاب والإجراء) عمل دي بوجراند De Beaugrande بعمل عبد القاهر، فيما يخص العناية بموقف منتج النص وبصياغة الكلام بأبعادها النفسية، يقول تمام حسان مشيرا لعمل دي بوجراند: “يذكرنا هذا بفكرة النظم لدى عبد القاهر الجرجاني الذي يتكلم عن النظم والبناء والترتيب والتعليق”([17]). إن عملية إنتاج النص عنده تمر بمرحلتين أساسيتين:
- المرحلة الأولى: نظم المعاني في النفس.
- المرحلة الثانية: نطق الحروف والكلمات.
وقد شكلت المرحلة الأولى محط اهتمامه وشغله الشاغل، يقول: “لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتُعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فَرغْتَ من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها”([18]). وهذه المعاني هي الأحكام التي يولدها المتكلم بتعليق معاني الألفاظ بعضها ببعض على هيأة مخصوصة، تلك المعاني التي تترتب في النفس أولا ثم تترتب الألفاظ تبعا لها في النطق. وهو بذلك يجعل لعقل المتكلم مكانا في العمل الفني باعتباره مصدرا للمعاني النفسية. وقد قدم تمام حسان تصورا لعملية إنتاج الكلام عند عبد القاهر، والتي تمر بأربع مراحل، وهي على التوالي: النظم، والبناء، والترتيب، ثم التعليق.
- النظم:
وهو نظم المعاني النحوية في النفس، وأن يعمد المتكلم إلى اختيار ما يناسب غرضه من هذه المعاني إذ يوردها على خاطره قبل أن يبني لها الكلمات. وهي مرحلة نفسية خالصة لا توصف بمفردات الكلمات ولا برصفها في سياق مستمر، ولا تقبل الدخول في أداء نطقي.
- البناء:
البناء هو نسبةُ مبنى صرفي مجرد إلى كل معنى، كأن ننسب إلى الفاعلية اسما مرفوعا، وإلى المفعولية اسما منصوبا (…) ف”عندما يحدد المتكلم المعاني النحوية التي يريد التعبير عنها ويتم نظمها في نفسه يبدأ في تأليف طوائف المعاني في صورة مجموعات تنتمي كل مجموعة منها إلى كلمة واحدة وذلك كالجمع بين المعنيين (حدث + زمن) الدالين على الفعل فيضم إليهما ما يصحبهما في نطاق النظم من أصل اشتقاق ليصوغ من الجميع فعلا مشتقا من الأصل الاشتقاقي المذكور”([19]).
- الترتيب:
جاء في الدلائل: “وأما «نظم الكلم» فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وتُرتبها على حسب تَرَتُّبِ المعاني في النفس”([20]). والمقصود هنا ترتيب المعاني في النفس لا ترتيبها في النطق، أي ترتيب الأمثلة ترتيبا معينا في الكلام، فلا يتقدم ما يستحق التأخير ولا يتأخر ما يستحق التقديم.
- التعليق:
يقوم المتكلم بتعليق معاني تلك الألفاظ على هيأة مخصوصة والربط فيما بينها من خلال علاقات نحوية ودلالية تُكوِّن معا خصوصية تركيبية، و”تتمثل هذه المرحلة في أمور مثل المطابقة وحروف الربط التي تؤدي إلى توثيق الأواصر بين عناصر الجملة على صورة تتحدى الفصل، والاعتراض، والاستتار، والحذف … إلخ. مما يجعل المعنى الكلي للكلام واضحا ولاسيما إذا أعانت القرائن السياقية والخارجية على هذا الوضوح”([21]). وسنضرب مثالا موضحا لتلك العمليات في جملة: «جاءَ زيدٌ مسرعاً إلى بيتِهِ».

لتأتي مرحلة النطق التي تترجم ما تمخضت عنه المراحل السابقة: «جاء زيد مسرعا إلى بيته». ويُرجع تمام حسان تعدد صور التركيب إلى الترتيب والتعليق، إذ يمكن أن ترد تلك الصور كالآتي: «إلى بيته جاء زيد مسرعا» – «مسرعا جاء زيد إلى بيته» – «مسرعا إلى بيته جاء زيد» – «زيد جاء مسرعا إلى بيته» …
لقد ركز تمام حسان على مفهوم “التعليق” عند عبد القاهر، معتبرا هذا المفهوم من المفاهيم المركزية في فكره، وبذلك يرى تمام أن “التعليق” هو:
- الفكرة المركزية في النحو العربي.
- الإطار الضروري للتحليل النحوي أو كما يسميه النحاة (الإعراب).
- مرجع الصحة والفساد والمزية والفضل.
- الكشف عن العلاقات السياقية وهو غاية الإعراب.
- إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية([22]).
وقد اقتفى مصطفى النحاس خطوات أستاذه تمام حسان فعرَّف “التعليق” بأنه “تحديد معاني الأبواب النحوية، وتفسير العلاقات بينها عن طريق القرائن المختلفة، أو بتعبير آخر: هو تفكيك بنية الإسناد، وبيان علاقات الكلم فيه من خلال ما يحدده المقام (…) ومعنى هذا أن مفهوم التعليق أو التعلق داخل في مفهوم النظم عند عبد القاهر، فكلاهما يتوفر على معاني النحو، وإمكانات التأليف بين الكلم، وما يجب أن يكون عليه الترتيب بين الكلمات في السياق”([23]). وهذا التعريف يبرز دور التعليق في انتظام الكلمات وفق سياق معين.
ويرى محمد حماسة عبد اللطيف أن “التعليق” بين الكلمات هو ما يكسب الجملة معناها. يقول: “أما “التعليق” النحوي ودوره المهم في عقد التركيب فقد كان منطلقا واضحا لتناول “الكلام” في موروثنا النحوي”([24]). وقد أشار صاحب (النحو والدلالة) في ثنايا دراسته لمفهوم التعليق إلى أهمية تعلق معاني الكلمات بعضها ببعض في صحة التركيب، ودوره الحاسم في تحديد سياق النص. يقول محمد حماسة عبد اللطيف: “التعليق بين الكلمات هو الذي يكسب الجملة معناها، أما الكلمات الحرة، أو المستقلة فلن تكون كذلك. وإن بدا بعض أنواع الشعر الحديث كذلك، أي كلمات متجاورة، على المتلقي أن يركبها بطريقته الخاصة ليقيم بينها نوعا من العلاقة تكسبها معنى”([25]). فأساس صحة الجمل، الاحتواء على معنى معين وحصول الفائدة من مجموع الكلمات. ويعد هذا المبدأ من أبرز ما توصل إليه عبد القاهر، فالمفهوم من مجموع كلمات الجملة هو مفهوم واحد، لا عدة معان، إن المعنى المستفاد هو محصول التعلق الناتج عن اتباع طرق تعليق الكلم المعلومة، وتوخي معاني النحو بين الألفاظ. والفصل بين مكونات الجملة أو إسقاط لفظ من الألفاظ أو تغيير ترتيبه يغير المعنى لا محالة، بل قد يؤدي إلى اختلاله.
ويشير البدراوي زهران إلى أن عناصر الجملة يتصل بعضها ببعض اتصالا مباشرا، إذ تتوالى تلك العناصر وفق ترتيب نسقي وسياق لغوي مناسبين، “فالمعنى اللغوي الذي هو محصول التعلق جاء ثمرة اتباع طرق التعليق بين الكلم، وتوخي معاني النحو بين مفردات اللغة، فجاء معنى واحدا لا عدة معان، ولا يمكن الفصل بين أجزائه، فما حصل عليه السامع هو ذلك المعنى ككل، وإن جزَّأه اللغويون في تحليلهم النحوي فهذه قضية أخرى وجانب آخر في الدرس اللغوي”([26]). ويضيف البدراوي زهران في السياق ذاته أن الدلالة جاءت “نتيجة لوجوه التعلق، والأحكام التي هي محصول التعلق، على الرغم من أهمية معاني المفردات إلا أنها ليست هي الدلالة. فمحال أن تخاطب شخصا بمفردات لا يعرف هو معانيها كما تعرف، ولكنك تتوخى ترتيبا خاصا في اللغة تلائم بينه وبين الموقف المخبر عنه”([27]).
أما مصطفى حميدة فيُعرّف التعليق بأنه: “تفاعل يتم في العقل بين دلالات الألفاظ ومعاني النحو، تنشأ من خلال علاقات الارتباط والربط بين تلك الدلالات، وذلك من خلال اختيار المتكلم بين ممكنات متعددة تتيحها اللغة من حيث دلالات الألفاظ ومعاني النحو، وتتفاوت المقدرة اللغوية للأفراد في هذا. أما النظم فهو نتاج لعملية (التعليق)، ويفهم من هذا أن التعليق ترتيب لدلالات الألفاظ في العقل، والنظم ترتيب للألفاظ ذاتها في الجملة الملفوظة”([28]). ويشير الباحث في هذا التعريف إلى أن النظم نتاج لعملية التعليق، هذه العملية المجردة ذات الطابع النحوي- الدلالي الصادرة عن معان نفسية، يترجمها المتكلم وفقا لإمكاناته اللغوية. ويعتبره كفيلا بعمليتي الربط والارتباط بين الألفاظ ومعاني النحو.
في حين يرى أحمد العلوي أن الجرجاني قد نظر إلى دور المتكلم في عملية إنشاء الكلام وبيان مزيته، فالمتكلم يقوم بتحويل المعاني النفسية إلى نظم يراعي العلاقات النحوية الدلالية، وذلك من خلال تعليق معاني الألفاظ بعضها ببعض، فالتعليق عنده هو أساس الاتحاد المعنوي بين الألفاظ داخل الجمل. يقول العلوي: “إن التعليق يؤسس علاقة تنشأ بين المتكلم وألفاظ اللغة، فالمتكلم ينشئ الكلام من خلال تلبس فكره معاني الألفاظ، وهذا التلبس لا يتم من خلال وجود الألفاظ، في حالة منفصلة أو مفردة. بل يكون ذلك التلبس من خلال انتظام الألفاظ في سياق يبرز العلاقات التي تسلك تلك الألفاظ في قوانين لغوية تكفل لها الانتظام في وحدات أكبر، هي سلسلة الكلام، التي تتألف منها الجمل ذاتها. إن الجرجاني في توضيحه النظري لتلك العملية يستعمل مصطلحا محددا، هو معاني النحو، ليدل على العلاقات التي تكتسبها الجمل، في ضوء انتظام يعلو حدود الجملة”([29]). وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها الباحث رشيد برقان الذي اعتبر أن التقدم في قراءة الدلائل كفيل بتوضيح مفهوم “التعلق”، حيث عمد الجرجاني إلى إسقاط نحو الجملة على نحو النص([30]).
“التعليق”، إذن، تصور نظري يندرج ضمن عمليات إنتاج الكلام من خلال علاقة المتكلم بسلسلة الكلام ذاتها، وهي علاقة تربط قصد هذا المتكلم وأوضاع اللغة وقوانينها. فهي بذلك تعد عملية نفسية – لغوية يجريها المتكلم في ذهنه؛ إذ يقوم بربط دلالات الألفاظ فيما بينها على نحو يجعلها تؤدي معنى معينا ينشأ عن طريق تضافر الفكر ومعاني الكلم والعلاقات النحوية – الدلالية التي تفرزها السياقات اللغوية، وهذه العملية تنجز في ومضة من الومضات الذهنية الخاطفة، وهي جزء لا يتجزأ من عملية كبرى وهي النظم، وهذا يعني أن “التعليق” ليس هو النظم كما ذهب إلى ذلك الباحث صالح بلعيد في قراءته لأركان نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني إذ يعتبر أن “النظم هو التعليق”([31])، والحال أن صاحب الدلائل يستعمل النظم في مواضع معينة و”التعليق” في مواضع أخرى، ويربط تحقق النظم بتحقق التعليق، مما يدل على أنّ المفهومين مختلفان عن بعضهما على الرغم من الارتباط الوثيق بينهما.
خاتمة:
يتحدد مفهوم “التعليق” عند عبد القاهر الجرجاني من خلال البحث في المستويات المعرفية التي اعتمدها لبناء هذا المفهوم (النحو والبلاغة وعلم الكلام)، فالبحث عن جذور فكرة “التعليق” عنده لا يمكن فصله عن السياق العقدي والكلامي الذي ميز القرن الخامس للهجرة. إذ ترتبط عملية “التعليق” بالكلام النفسي عند المتكلم، من خلال ما يجريه من عمليات نفسية وذهنية في عقله، حيث يقوم بربط دلالات الألفاظ في ما بينها على نحو يجعلها تؤدي معنى معينا. بذلك يعد “التعليق” مطلبا من مطالب الصياغة والتأليف، الذي يتجسد من خلال قوانين لغوية محددة تضمن للألفاظ والجمل التماسك والالتحام، وهذه القوانين هي التي عبَّر عنها الجرجاني ب[طرق التعليق ووجوهه].
وقد تلقى الباحثون العرب المحدثون هذا المفهوم في دراساتهم اللغوية والبلاغية، وعلى الرغم من تباين آرائهم وتأويلاتهم فقد بينوا أهميته ومركزيته في نظرية النظم الجرجانية، وعدوه أساس الصياغة ومرجع الصحة والفساد والمزية والفضل. كما ربطوه بالعمليات الذهنية المجردة ذات الطابع النحوي- الدلالي الصادرة عن معان نفسية، والتي يترجمها المتكلم وفقا لإمكاناته اللغوية، مما يكسب التركيب معناه.
هوامش:
([1]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، ط 3، مطبعة المدني، جدة، 1992، ص 417.
([2]) تمام حسان، الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د.ط، عالم الكتب، القاهرة، 2009، ص 276.
([3]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صص 49 – 50.
([5]) مصطفى حميدة، نظرية الربط والارتباط في تركيب الجملة العربية، ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، 1997، ص 60.
([6]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، (المدخل)، ص 4.
([8]) مصطفى حميدة، نظرية الربط والارتباط، صص 64 – 65.
([9]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 466.
([13]) الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، تحقيق محمد عبده عزام، ط 5، ذخائر العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د.ت)، ص 78. (البيت رقم 6 من قصيدة في مدح مالك بن طوق التغلبي).
([14]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 406.
([17]) دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: تمام حسان، ط 2، عالم الكتب، القاهرة، 2007، ص 43. (الهامش الأول).
([18]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صص 53 – 54.
([19]) تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 2، ط 1، عالم الكتب، القاهرة، 2006، ص 335.
([20]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص49.
([21]) تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 2، ص 336.
([22]) انظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، د.ط، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1994، صص 181 – 189.
([23]) مصطفى النحاس، التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي، ضمن كتاب: تمام حسان رائدا لغويا بحوث ودراسات مهداة من تلامذته وأصدقائه، إعداد وإشراف: عبد الرحمان حسن العارف، ط 1، عالم الكتب، القاهرة، 2002، ص 346.
([24]) محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي – الدلالي، ط 1، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص 12.
([26]) البدراوي زهران، عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني المفتن في العربية ونحوها، ط 1، دار العالم العربي، القاهرة، 2009، ص 204.
([28]) مصطفى حميدة، نظرية الربط والارتباط، ص 11.
([29]) أحمد العلوي، الطبيعة والتمثال مسائل عن الإسلام والمعرفة، د.ط، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، 1988، ص 82.
([30]) انظر: رشيد برقان، آليات ترابط النص القرآني، د.ط، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 166.
([31]) صالح بلعيد، نظرية النظم، د.ط، دار صوماك، الجزائر، 2002، ص 143.
لائحة المصادر والمراجع:
- أحمد العلوي، الطبيعة والتمثال مسائل عن الإسلام والمعرفة، د.ط، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، 1988.
- البدراوي زهران، عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني المفتن في العربية ونحوها، ط 1، دار العالم العربي، القاهرة، 2009.
- تمام حسان، الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د.ط، عالم الكتب، القاهرة، 2009.
- تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، د.ط، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1994.
- تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 2، ط 1، عالم الكتب، القاهرة، 2006.
- الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، تحقيق محمد عبده عزام، ط 5، ذخائر العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د.ت).
- دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: تمام حسان، ط 2، عالم الكتب، القاهرة، 2007.
- رشيد برقان، آليات ترابط النص القرآني، د.ط، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015.
- صالح بلعيد، نظرية النظم، د.ط، دار صوماك، الجزائر، 2002.
- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، ط 3، مطبعة المدني، جدة، 1992.
- محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي – الدلالي، ط 1، دار الشروق، القاهرة، 2000.
- مصطفى النحاس، التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي، ضمن كتاب: تمام حسان رائدا لغويا بحوث ودراسات مهداة من تلامذته وأصدقائه، إعداد وإشراف: عبد الرحمان حسن العارف، ط 1، عالم الكتب، القاهرة، 2002.
- مصطفى حميدة، نظرية الربط والارتباط في تركيب الجملة العربية، ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، 1997.
References:
- Ahmad Al-Alawi, Al-Tabi‘ah wa al-Timthal: Masa’il ‘an al-Islam wa al-Ma‘rifah, d.t., Al-Sharika al-Maghribiyyah li al-Nashirin al-Muttahidīn, Rabat, 1988.
- Al-Badrawi Zahran, ‘Ālim al-Lughah ‘Abd al-Qāhir al-Jurjānī al-Muftan fī al-‘Arabiyyah wa Nahwiha, Ṭ.1, Dār al-‘Ālam al-‘Arabī, Cairo, 2009.
- Tammām Ḥassān, Al-Uṣūl: Dirāsah Ibstīmūlūjiyyah li al-Fikr al-Lughawī ‘inda al-‘Arab, d.t., ‘Ālam al-Kutub, Cairo, 2009.
- Tammām Ḥassān, Al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma‘nāhā wa Mabnāhā, d.t., Dār al-Thaqāfah, al-Dār al-Bayḍā’, 1994.
- Tammām Ḥassān, Maqālāt fī al-Lughah wa al-Adab, J.2, Ṭ.1, ‘Ālam al-Kutub, Cairo, 2006.
- Al-Khaṭīb al-Tabrīzī, Sharḥ Dīwān Abī Tammām, taḥqīq: Muḥammad ‘Abduh ‘Azzām, Ṭ.5, Dhakhā’ir al-‘Arab, Dār al-Ma‘ārif, Cairo, Miṣr, (d.t.).
- De Beaugrande, Al-Naṣṣ wa al-Khiṭāb wa al-Ijrā’, tarjamah: Tammām Ḥassān, Ṭ.2, ‘Ālam al-Kutub, Cairo, 2007.
- Rashīd Barqān, Āliyyāt Tarābuṭ al-Naṣṣ al-Qur’ānī, d.t., Ifrīqiyā al-Sharq, al-Dār al-Bayḍā’, 2015.
- Ṣāliḥ Bula‘īd, Naẓariyyat al-Naẓm, d.t., Dār Sūmāk, al-Jazā’ir, 2002.
- ‘Abd al-Qāhir al-Jurjānī, Dalā’il al-I‘jāz, qara’ahu wa ‘allaqa ‘alayhi: Maḥmūd Muḥammad Shākir, Ṭ.3, Maṭba‘at al-Madanī, Jeddah, 1992.
- Muḥammad Ḥamāsah ‘Abd al-Laṭīf, Al-Naḥw wa al-Dalālah: Madkhal li Dirāsat al-Ma‘nā al-Naḥwī – al-Dalālī, Ṭ.1, Dār al-Shurūq, Cairo, 2000.
- Muṣṭafā al-Naḥḥās, Al-Ta‘līq al-Naḥwī wa al-Fikr al-Tawlīdī al-Taḥwīlī, ḍimn kitāb: Tammām Ḥassān Rā’idan Lughawiyyan: Buḥūth wa Dirāsāt Muhdāt min Tilāmidhatihi wa Aṣdiqā’ihi, i‘dād wa ishraf: ‘Abd al-Raḥmān Ḥasan al-‘Ārif, Ṭ.1, ‘Ālam al-Kutub, Cairo, 2002.
- Muṣṭafā Ḥamīdah, Naẓariyyat al-Rabṭ wa al-Irtibāṭ fī Tarkīb al-Jumlah al-‘Arabiyyah, Ṭ.1, Al-Sharikah al-Miṣriyyah al-‘Ālamiyyah li al-Nashr, Cairo, 1997.