عبد الرحيم رفيقي
ملخص البحث
عبد الرحيم رفيقي: باحث في جامعة السلطان مولاي سليمان – المغرب
تستهدف هذه الورقة البحثية تناول تجربة شعرية تمثل الشعر المعاصر في المغرب، والحديث هنا عن تجربة الشاعر المغربي محمد بنطلحة الذي تلقى تكوينا علميا رصينا متح فيه من مناهل ثقافية خصبة رفدت من حقول معرفية تاريخية وفكرية وفلسفية وتراثية وصوفية واقعية وتخييلية، من أجل بلورة تجربة إبداعية مغربية تمزج بين حساسيات شعرية ترسخ فكرة الذات المتحررة من رواسب الجمود والتقليد والتبعية، سعيا إلى تطوير قوالب فنية مستحدثة تستجيب لتطلعات المجتمع، وتعلي من صوت طبقاته الهامشية المنبوذة والمغيبة، عبر تبنيه مشروعا شعريا يمتلك رؤيا فنية رمزية وأسطورية بلاغية تؤطر حاضر ومستقبل القصيدة المغربية.
لقد ترسخت هذه الفكرة التحررية في الممارسة الشعرية لدى محمد بنطلحة منذ البدايات الأولى لتجربته الشعرية، وصارت أكثر نضجا بفضل ما حققه من تراكم، لهذه المسوغات ينبغي الوقوف عند أحد أعماله التي تمثل لتطور الحساسية الشعرية لديه، باختيار ديوانه الشعري السابع (قليلا أكثر) الذي صدر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع بعد سلسلة من الأعمال الإبداعية التي مهدت الطريق لتبنيه مشروعا شعريا حداثيا، ولمعرفة خصوصية تجربته الإبداعية، لابد من مقاربة عدد من القصائد التي يحتويها الديوان، من خلال النص والدلالة، قصد تتبع مظاهر المعاصرة الشعرية المغربية لديه.
الكلمات المفتاحية: النص والدلالة، الممارسة الإبداعية، البناء الدلالي، تقنيات تعبيرية.
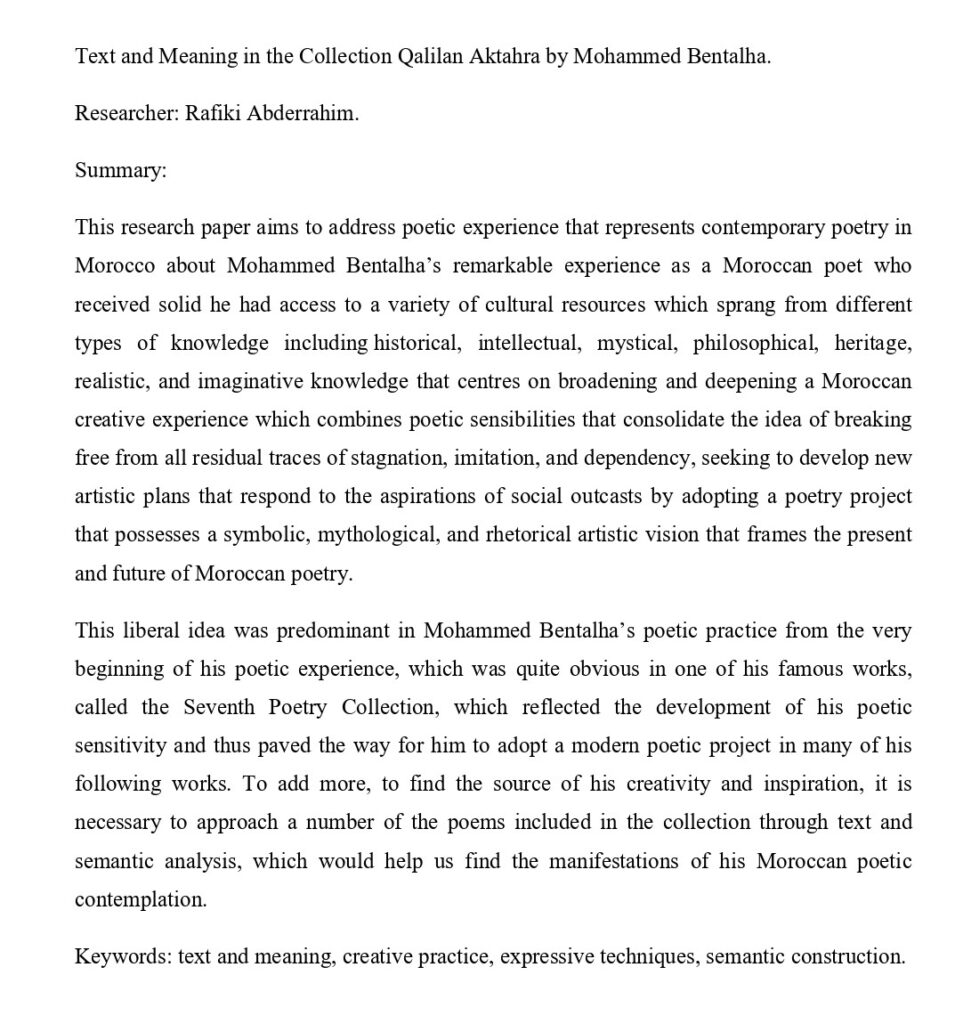
مقدمة:
شرع الخطاب الشعري المغربي بمختلف تلويناته في البحث عن مكانة تليق به ضمن الخطابات النقدية الأخرى، مستفيدا من مدارس وتيارات عربية وغير عربية دخلت الجامعة المغربية بفضل انفتاحها على الآخر، وساعدت في ذلك الترجمة والصحافة والمثاقفة، التي دفعت الباحث إلى حمل مشعل التفتيش عن المعنى وتشيد الدلالة عبر توظيف آليات وأدوات منهجية كفيلة بتشريح النص الأدبي وتتبع سياقاته وكشف علائقه الخفية، وتعد القصيدة المغربية المعاصرة، من بين الخطابات التي حظيت باهتمام الباحثين، ووجدت نفسها أمام أسئلة كبرى تبحث عن الهوية والخصوصية، وتدعو إلى تجاوز المآزق التي سقط فيها الشاعر المغربي فيما قبل، وهي رغبة واضحة لدى الباحث المغربي، في التأسيس لنص شعري يستخدم من الآليات والأدوات والرؤيا ما يكفيه أن يبني فرادته وخصوصيته المغربية.
وفي هذا السياق يمكن استحضار عدد من الدراسات النقدية التي واكبت النص الشعري المعاصر بالمغرب، من قبيل (القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد) لعبد الله راجع، و(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: مقاربة بنيوية تكوينية) لمحمد بنيس، و (الشعر المغربي المعاصر: سبع خطوات رائدة) لمحمد الميموني، و(المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر) لصلاح بوسريف ، وغيرها من الأعمال النقدية التي درست التجربة الشعرية المعاصرة في المغرب، وسعت إلى إيجاد إجابات عن أسئلة جوهرية ظلت عالقة لعقود طويلة، في بحثها الحثيث عن كتابة شعرية معاصرة تحمل هوية كتابة مغربية مواكبة للتحولات الثقافية والسياسية والحضارية والتاريخية، التي رسخت وعيا لدى الشاعر المغربي بالواقع والذات، حيث سلك مسارات متعددة في بحثه عن عوالم فنية جديدة تختزن مواقف الذات المبدعة الساعية إلى التحرر من مغالق التقليد ومآزق التبعية، يقول عبد الله راجع خلال حديثه عن مسألة تحرر الشاعر: “إن مبدأ التحرر مبدأ أساسي، ومن يرفض هذا المبدأ يكشف عن سوء فهم لحركية الإبداع الفني عموما، والإبداع الشعري على وجه الخصوص، ولا يمكن أن يتم أي تطور شعري خارج هذا المبدأ”[1]، لقد تشكلت الممارسة الإبداعية المعاصرة في المغرب ضمن سياقات اجتماعية وسياسية موسومة بالصراع بين مكونات المجتمع، إذ انبثقت عنه أسئلة قلقة لدى الشاعر تختبر الواقع والمجتمع، يتحدث راجع عن هذه المسألة بقوله “لا بد من الإشارة إلى أن الهم المغربي لبث واضحا في هذه الكتابات بنسبة تكبر أو تقل تبعا لانشغال الشاعر المغربي بقضايا الساعة في مجتمعه”[2] ، فقد استفاد من تجارب إبداعية متنوعة، رسخت له ذلك الجانب الفني الداعي إلى ضرورة الانفتاح على الراهنية الشعرية المتجددة والممتدة في الرؤيا والزمان، حيث “انفجر النص الشعري المعاصر بالمغرب من الرغبة الملحاحة في تحطيم نص شعري آخر، وهو الشعر العمودي الذي كان وما يزال، يؤدي وظيفة غير مستقلة في مجتمع تحولت بعض أسسه المادية عن وضعها القديم، وتجسد فيه الطموح إلى التغيير والتحرر والابتكار”[3]، والتخلص من التجارب السابقة التي طالها اليأس والجمود، عبر تجريب تقنيات تعبيرية وجمالية جديدة تمثل دعامة التأسيس لشعرية مغربية معاصرة موسومة بالفرادة والتميز، تستهدف الفكر التقليدي عبر خلخلة البنى الاجتماعية الموروثة والتصورات الثقافية والسياسية البالية، وتدعو إلى ايقاظ النائمين على وسائد الماضي، وقد تفتقت هذه الرؤيا الجديدة عن صراعات وحساسيات شعرية متباينة، وذوات قلقة مهووسة بأسئلة الوجود واليأس والألم والأمل والحلم، معطيات تترجم “وجود رغبة كبيرة لدى الشاعر المغربي المعاصر في إنجاز قفزة نوعية للوصول بالقصيدة المغربية إلى مكانتها اللائقة بها”[4]، عبر منجز شعري مغربي معاصر، يبرهن على أن التجربة الإبداعية المغربية بمقدورها أن تنافس وتترك صداها في الساحة الأدبية العربية.
وقد حمل لواء البناء والتأسيس للشعر المعاصر بالمغرب عدد من الشعراء، حيث برزت فيه كتابة شعرية جديدة تضاهي نظيرتها المشرقية، مع كل من حسن لآمراني (الحزن يزهر مرتين، 1974) و(مزامير، 1975) ومحمد الأشعري (صهيل الخيل الجريحة، 1978) وعبد الله راجع (الهجرة إلى المدن السفلى، 1976).
ظهرت مع هذا الجيل بوادر كتابة واعية بالواقع والظروف المحيطة به، وتطلعات الشارع المغربي، والمشاعر والأحاسيس التي يكتنزها الشاعر وفي هذا الصدد يقول محمد بنيس: “بدأ الشعراء المعاصرون بالمغرب وقبلهم بالمشرق، يكتبون وهم واعون تحكمهم درجات متفاوتة من الوعي”[5]، ملبين نداء مجتمعهم ومستجيبين لحاجات ورهانات الواقع، التي فرضت عليهم زعزعة ثوابت موروثة سلفا، شاخت وحان الوقت لاستبدالها بمشروع إبداعي واع بحتمية التجاوز والتغير، مشروع مغربي الهوية يسعى إلى تقويض تقنيات الكتابة التقليدية اليائسة والجامدة وإحلال محلها كتابة شعرية متجددة مستمرة، تسعف الشعراء في تحرير ذواتهم من ربقة التقليد والاسفاف والجمود، وتدعوهم إلى الانخراط في مسارات واختبارات حقيقية واعية، تترجم حساسية الذات الشاعرة، تسمع صوتها الفردي والجماعي، لأن “المتن الشعري المعاصر يستقل عن غيره من المتون السابقة عليه، أو الموجودة معه في نفس الفترة التاريخية، ببنية متكاملة (…) ، وهذه البنية هي التي تكونت فرادتها من السقوط والانتظار”[6]، والتجاوز، وهدم القوالب التقليدية الجاهزة الموروثة، وبناء محددات جديدة تناسب روح العصر، ومستجدات الواقع. تستمد قوانينها تبعا لنوعية النص الشعري المعاصر.
للحديث عن الشعر المغربي المعاصر ميزة، تنقل الدارس إلى التفتيش عن قوانينه وقواعد كتابته، وهذه الورقة البحثية غير كافية لتناوله بكل تفاصيله وجزئياته، مما يجعل دائرة التنقيب والبحث تضيق لتطرق تجربة إبداعية واحدة من ضمن تجارب عديدة مثلت للشعر المغربي المعاصر، أخص بالذكر هنا تجربة الشاعر المغربي محمد بنطلحة، وتتقلص هذه المساحة أكثر بالوقوف عند مقاربة ديوانه(قليلا أكثر) الصادر عن دار الثقافة في طبعته الأولى سنة 2007، مقاربة تتوخى السفر في عوالم النص والدلالة التي يكتنزها.
تجربة محمد بنطلحة الشعرية:
تستمد تجربة محمد بنطلحة الشعرية مادتها من متخيل شعري خصب مفتوح على نوافذ فكرية وفلسفية وجمالية كائنة وممكنة ظاهرة وخفية واقعية وتخيلية، بلاغية ورمزية ذات أبعاد متشعبة، تستحضر الذات وأسئلتها وتستدعي التاريخ والذاكرة تعالج الهامشي والمسكوت عنه والمجهول عبر ايماءات وإشارات تواكب مساعي صوت الشاعر وإيقاعه النفسي، وشغفه الدائم نحو بناء قصيدة مغربية معاصرة تعيد تشخيص الواقع وتترجم إحساس الإنسان بالذات والوجود في عوالم بحثه عن إجابات لأسئلة واعية تعزز تشكيل المعنى وبناء الدلالة وتسعف المبدع في استنطاق النص والتوليف بين عناصره الجمالية والدلالية المتنافرة، عبر تطويعها وجعلها أكثر انسجاما في متخيله الشعري.
تسعفه في ذلك، أدوات فنية ومنهجية تجاري تلك اللغة الجديدة بأسرارها وسياقاتها وشعريتها وانفتاحها على الفكر والفلسفة والذاكرة وفق ايقاعات شعرية معاصرة تتجاوز ما هو ماض وتعمل على مواكبة تحولات الذات المبدعة داخل النص الشعري ارتفاعا وانخفاضا صعودا وهبوطا، تعزز هذا البناء الدلالي الصورة الشعرية التي تنحت عناصرها من الرموز والومضات والايحاءات التي ترسم عوالم الشاعر وطموحاته الفردية وتنير الطريق للمتلقي خلال بحثه عن الدلالة وإنتاج المعنى.
- توصيف ديوان قليلا أكثر:
يشكل ديوان (قليلا أكثر) لمحمد بنطلحة العمل الشعري السابع بعد رؤى في موسم العوسج (1970) ونشيد البجع (1989) وغيمة أو حجر (1990) وسدوم (1992) وبعكس الماء (2000) وليتني أعمى (2000)، الذي صدر عن دار الثقافة المغربية للنشر والتوزيع ضمن سلسلة من التجارب الشعرية يتوزع على خمسة أبواب، وهي، قدر إغريقي، وماذا سأخسر؟ والمرحلة الزرقاء، وجينالوجيا، ونجوم في النهار، وهو تمرة تجربة شعرية اختمرت كلماتها ورسمت معالمها الإبداعية على أرضية صلبة، ونار هادئة، متحت من حساسية شعرية مغربية، قوضت القوالب التقليدية الجاهزة وهدمت التصورات الانطباعية المسبقة ورسخت لمنعطفات وتحولات جديدة، تحمل مواقف شعرية جريئة تختزن صرخة الشاعر الحالمة ضد كل جفاء روحي وجدب قيمي وفكري وسياسي، عبر أسئلتها الطيعة، وأدواتها الفنية المواكبة لمستجدات العصر ومشاهده وفوارقه الاجتماعية والطبقية، ومتغيراته المجالية حيث عالم يتطور ويتغير وآخر جامد يكتفي بالمشاهدة والتحسر والألم.
- النص والدلالة في ديوان (قليلا أكثر) لمحمد بنطلحة:
يطرق الشاعر في هذا الديوان عالما جديدا يتنقل عبره في فضاءات وأزمنة مختلفة، يستحضر التاريخ والفكر والفلسفة و الدين والفن ويصور حلقات صراع الأنا والآخر، من خلال استدعاء لغة مثقلة بالدلالات، بمقدورها التسرب عبر فجوات عالم القصيدة المغربية المعاصرة، تتقمص أدوارا متعددة على خشبة مسرح الواقع شخصياتها هلامية وجودية وعدمية أحيانا، بإمكانها استنطاق الحضارة والتاريخ وتوليد الدلالة وإنتاج المعنى.
تقودنا هذه التجربة الشعرية المغربية إلى الاصغاء لبعض القصائد التي يحتويها الديوان، وفي حضرة بوح الشاعر بإمكاننا البحث عن الدلالة التي تختزنها نصوصه، ففي قصيدة “من أجل قبضة ثلج” قد اتخذ الشاعر عنصرا من الطبيعة عنوانا لنصه، حيث وظف الثلج توظيفا شاعريا صور عبره حاله النفسية الموسومة بالحزن واليأس الذي يتحول إلى صلابة وبرودة قاسية، يندفع نحوها فيقبض على قطعة الثلج تلك، رغم شدة الألم التي يشعر بها، ينجح في إذابتها بيديه ويترجمها إلى أفكار ومواقف شاعرية يظهر من خلالها شخصية عمر المهزوم في أسره الأزلي، مغمض العينين، لا يرى العدل والحق واليقين الذي ألفه الشاعر فيه، فيكتفي باستعادة الذكريات، عبر أطياف وومضات تظهر وتختفي، متسللة عبره هذه الكلمات إذ يقول:
عمر بأسره
والحرب الأهلية قائمة
بين الماء
ورغوته
المحيط عرفناه
سمكة
والهدير، كالحقائب الموصدة، كم نقلناه
من كتف إلى كتف
وفي الأخير،
إنسان الثلج لم يخطئ:
الزمن ليس سمكة[7].
تحدو الشاعر هذه الإحالة الرمزية التصويرية في المتخيل العربي، أثناء تشريحه للواقع، واكتشافه للحرب الأهلية المشتعلة، بين دعاة السلم والسماحة وهم قلة وبين صور الاستبداد وانتهاك حقوق الأفراد، وتقيد الذات وتشديد الرقابة عليها، ، لكن الشاعر بحكمته يستطيع الانفلات عبر قبضته المحكمة على قطعة الثلج، التي يحولها من وضع صلب قاس إلى حال جديد، ينطلق من خلاله في حفر مسارات حرة تتجاوز الحدود الكائنة، فالشاعر عبر هذه اللوحة الفنية التعبيرية يعرض أفكارا فلسفية وجودية تكشف عن مستويات الطموح، وتسعف في تفجير الذات لذائقتها الشعرية، تتخذ من الحرب الاهلية مشاهد لمنعطفات وتحولات جديدة ، تفتقت بعد اصرار الشاعر وعزمه تحطيم الحواجز، وخلق منافذ، بفضل خبرته ورؤيته المتبصرة النابعة من تجربة.
وفي نص (بحبر أقل) انطلق محمد بنطلحة من الإحالة على الضياع والعزلة والاغتراب والسفر في عوالم الخيال، قادته هذه الرحلة إلى أراض متعددة للبحث عن حرية وانسجام أكبر، تكررت أسفاره ورحلاته مرات متعددة، توخى من خلالها تطهير نفسيته القلقة الضائعة بين ملتبس الفناء والخلود والموت والحياة، يقول في مستهل نصه:
(كم ذهبت إلى آخر الأرض
أنا،
الزائل
والأزلي
كم وفيت للحمائم
وكم غدرت بالصقور
في أحد الأسفار
سرط القدر لعابه. وعرض علي
في مقابل الجزء الأول من مذكراتي
ثمنا باهظا:
أن أجعل من جسدي
ساحة حرب
وأن يرى
ويسكت[8].
يترجم هذا المشهد الشعري ثنائية متعددة، تحيل على صراع نفسي داخلي، يؤثث رمزية الوفاء والصدق والسلم (الحمائم) ورمزية الموت والغدر والفتك والافتراس (الصقور)، فالحمائم والصقور مجرد انعكاسات لذات الشاعر وأحوالها وأهوالها ومحطاتها المتحولة عبر السفر والزمن، إذ يستحضر في إحدى سفرياته لعبة القدر والذاكرة، وصدى الحرب بينهما، داخل جسده، لكن لسانه عجز عن الكلام رغم هول المعركة، وقد عرض عليه ثمنا باهظا مقابل هذا الصمت. حيث يقول:
على الورق،
هزمت
وانهزمت
وفي الحقيقة، لم أكن أنا من ذهب
إلى آخر الأرض
لم أكن أنا صاحب الجبروت
وإنما، ظلي[9].
يعترف الشاعر في آخر القصيدة أنه منتصر ومهزوم، والحرب مشتعلة بين أفكاره وذاته الحالمة، وواقع لم يسعفه في بسط أحداث هذه المعركة، مما يفتح آمام الذات أسئلة ومنعطفات أخرى ستظل عالقة، أو أجوبتها قد تكون مجهولة.
أما في قصيدة (أنا سليل الهمج)فالشاعر يبحث عن انسجام الذات في متاهات الواقع، وينطلق من فضاء المقبرة والحانة الذي يشكل حجز الزاوية لبداية تشيد الدلالة وترجمة الرؤيا التي يتبناها بشأن واقع ينفر منه لأن طموحاته تختلف تماما معه، حيث تأخذ درجة تماسكها وانسجامها ولحمتها من نسق فكري وفلسفي طموح يرفض كل اجحاف لروح الإبداع ويسعى إلى جمع وتكثيف أفكاره وتطلعاته الإيديولوجيا وفق نظرة فلسفية ثاقبة للأشياء، وهي رؤيا ذهنية يرفعها الشاعر إلى أقصى درجات الانسجام والتلاحم في منجزه الشعري، يرفض عبرها وجوده الأول الذي لم يختره بنفسه، بل كان بقضاء وقدر، طفولة طبعها الجمود والسكون، والتعود على القبول بأمر الواقع، بداية اعتبرها ولادة في مقبرة بها موتى منعدمي الإحساس والشعور، لكن نهايته مسؤولية فردية واختيار ذاتي نابع من وعي متشكل، متصاعد عبر هذه الكلمات إذ يقول في مستهل القصيدة:
في مقبرة ولدت
وفي حانة أموت[10].
إن هذا الوعي الذي بدأ يتشكل لديه عبر احتكاكه بالمحيط وتشبعه بأفكار وتصورات عجل برفضه للواقع القائم والمواقف السائد من الوجود الذي كان يحمل دوما أفكارا غير طموحة، ولا تجد أجوبة ممكنة للقضايا الشائكة، وذلك بالتطلع نحو نحو وعي ممكن لدى الشاعر موسوم بالنظرة الفلسفية المتبصرة للأشياء وفق تصور مستقبلي لا رجعة فيه للماضي، أو بالأحرى وعي بتصور فكري جديد يعي المعضلات الاجتماعية ويسعى إلى خلق توازن في العلاقات والتصورات، في هذا الشأن يقول محمد بنطلحة:
حكيم كالرماد
وحيثما حللت، كألوان الطيف
لا أستريح
أتجدد
صبرا علي[11].
فالشاعر هنا يجسد شخصية متمردة على عالمها وواقعها ومجتمعها الذي يعيش تمزقا جليا في عالم فظ، يطبعه الاستلاب والانحطاط والتشيؤ، يرغب في تغييره عبر نشر قيم الشاعر الحكيم الممتلك لرؤيا أوسع تتجدد باستمرار وتمتد نحو أفق أكثر رحابة، تحاكم الماضي، تنسج خيوط المستقبل، بعزم وروية وحكمة. تظهر هذه الذات الشاعرة الفردية الحرة مرة أخرى لتقفز على الشرائط الموروثة، يقودها تمردها إلى الإيمان بالإرادة الواعية بضرورة المشاركة في خلق تجديد محيط الإنسان بطريقة حرة ومسؤولة بعيدة عن الإسراف في كل أشكال الزيف والخيال والوهم، سلاحه في تشكيل هذه الرؤية الفردية المنفلتة من الرقابة يعتمد مقومان اثنان رئيسان هما: اللغة التي تمثل فضاء الخلق والإبداع، والبناء الفني والمادي اللذان يسعفان الشاعر في البوح بمكنونات الذات التي تمكنت من كسر الحدود الوهمية وتجاوز الأفكار السائدة، عبر تمسكها برؤية فلسفية جديدة محايثة للإنسان متبصرة بواقعه ومعاناته جراء صراعاته ونزعاته، يقول الشاعر في هذا الشأن:
هنيهة وأخرق ما أريد
قبالة شواطئ اللغة، ناقلة بترول
تحت أجفان العائلة، رداء الغطس
وتحت أجفاني، معاهدة شنغن
وقانون الصحافة
ماذا سأخسر ؟[12].
يبدو الشاعر حالما متمسكا بنظرة حدسة واضحة يعقبها الفحص والتدقيق لإثبات حقائق حرة قادرة على إنشاء معادلة للوعي بالقضايا الثقافية والفكرية المترجمة للوشائج بين الفعل الإبداعي الفردي والتصور الفلسفي الجماعي الذي يتحكم في عمله ويعد حجر الزاوية في تشكيل الدلالة وانفتاحها على ممكنات القراءة المتعددة، لبلوغ جوهر عوالمها وكشف مساعيها، حيث يقول:
كائن هيروغليفي، أنا
في أوقات الفراغ
أبيع الخمور
للموتى
وفي أوقات الشدة
أقول للحضارة
لست أمي[13].
تظهر معالم الغموض والغرابة عندما يعتبر ذاته الشاعرة كأئنا هيروغليفيا، حيث يمنح للمتلقي مساحة أوسع للقراءة وإنتاج المعنى حينما امتهن تجارة الخمر مع الموتى لحظة فراغه، مما يضمر أشكالا من العبث الذي تجاوز المنطق نحو اللامنطق، كيف يعقل أن يمنح للموتى الخمر، هل المعزى من ذلك، استفزاز أذهان جامدة، علها تستقيظ من نومها العميق وتعي ما يحيط بها عبر تناول جرعات من خمرة الإبداع، لكنه سرعان ما يعلن بشكل جلي فعل الرفض للحضارة التي ينتمي إليها. هذا الرفض للحضارة الأم يقوده إلى مغامرة جديدة يسعى من خلالها إلى النجاح في سرقة تعويذة من تحت رأس المومياء لتنبلج له مسالك الأفق، حيث يغوص في عوالم الذات ويمسك بجوهرها، ويتعرف إلى أسرارها وقلقها وهوسها وتطلعاتها وفضاءاتها المتعددة، تظهر هذه الدلالات في المقطع الآتي:
أيضا
أغامر
وأسرق التعويذة
من تحت رأس كل مومياء
وجدتها في طريقي[14].
لقد منح الشاعر في المشهد الشعري الموالي لذاته مجالا ممتدا رفض عبره الحساب الذي يحد من حريته ويخضعه لكل أشكال الرقابة، التي تقيد إرادته، وتفسد ممارسته الإبداعية، ويحب الهندسة التي يعتبرها وسلية لرسم عوالم شعورية بكيفية تنسجم مع تصوراته وإرادته، نقرأ في آخر القصيدة:
(أوف
أنا من هرقت فوق الأرض
قارورة المعنى
أحب الهندسة
ولا أحب الحساب
عندي
يوم الحساب مضى
ولن يعود
ليس ل E.mail @[15] .
لقد سعى الشاعر إلى التخلص حتى من الحسابات الإلكترونية كذلك لما تختزنه من بيانات تشكل شاهدا عليه، تقيد حريته، ومن ثم يرفضها وينطلق في تحليقه مسافرا في مغامرات الإبداع كما الشأن بالنسبة للحمام الزاجل، يبعث برسائل مشفرة، تضمر تشبثه بالانتصار رغم مرارة الهزيمة والمعاناة التي مني بها في غير ما مرة.
سفر الشاعر في بناء الدلالة عرف منعطفا جديدا في قصيدة تحمل عنوان (محمد بنطلحة ) أدرج الشاعر عبرها شخصية مستعارة تحمله اسمه الذي يعتبره أنه ليس اسمه الحقيقي، بل المتخيل، المستوحى من التاريخ الإغريقي الذي بناه هيرودوت حيث قابل وجوه وأجساد وتجارب لكن رحلة بحثه لا تنتهي عند شخصيات أو أحداث بعينها، فكلما عثر على شيء معين بدا له غامضا وملتبسا صعب الفهم والاستيعاب، يحتاج إلى مسافة من التفكير والبحث لتعرف كوامنه وخفاياه، إذ يقول في مستهل القصيدة:
محمد بنطلحة
اسم مستعار
عند هيرودوت: هو الذي حينما عثر على برج بابل
في صندوقه البريدي
عثر أيضا
على رقعة شطرنج
وحكمة قديمة. أعلى مراتب الحقيقة، الكذب[16].
لقد بدت طريقة ترتيب الأحداث والوقائع عنده ملغومة موسومة بالتعقيد تعمد الايحاء والايماءات، تحيل على الكذب تارة وتحيل على الحقيقة واليقين تارة أخرى، وينبئ ذلك بصراع أزلي بين الحقيقة والكذب في كل مجالات الحياة، فالعلم على سبيل المثال لا الحصر يشيد فرضياته للوصول إلى حقيقة ما، يفندها التاريخ، ويعرض زيفها، فتحل محلها حقيقة أخرى، تتجاوز سابقتها، وتبرهن على يقين جديد، وبالتالي فالحقائق مختفية في فضاءات مجهولة، كشفها مؤجل، مرتبط بالمستقبل المستمر، مادام الحاضر لا يستدعي سوى ذكريات . يؤكدها بقوله:
واليوم، حيث كل الحقائق مؤجلة: النبيذ إلى الغد.
والذكريات إلى حياة غير هذه. ماذا سأفهم؟ في موقع:
خلية نائمة. وفي آخر لا ينام أبدا
أنا كيف أكون معاصرا له
وكل ما بيننا، منذ ما قبل التاريخ
ظلال
وأقنعة[17].
هذا أمر شديد التعقيد بالنسبة للشاعر الذي يطرح أسئلة قلقة تخص العصر التاريخ والأقنعة والوجوه. في عالم يسوده الضياع والأسى والخسارة وبطء الزمن، يبحث فيه الشاعر عن وجوده الفردي في ثوب دراماتيكي يخرق سترة الذات ويتسرب إلى عمق الشعور والوعي الفردي، يذيب المسافة الفاصلة بين الحقيقة والزيف، يعلي من صوت الفرد التائه الحائر الباحث عن معنى لوجوده.
أما قصيدة (حين خضع البحر للإسكندر) فإنها تحمل مفارقات دلالية تخرق المألوف لدى القارئ منذ العنوان الذي يستحضر البحر بأسراره وامتداده وانسيابيته وعبابه القوي، وشخصية الإسكندر التاريخية التي تحيل على ملك مقدونيا، القائد العسكري الفاتح، فهي موازنة بين قوتين قوة طبيعية يمثلها البحر وقوة بشرية يمثلها الاسكندر، هذا المشهد يستدعي ذلك الصراع بين قوى الطبيعة ورغبة الإنسان في السيطرة عليها واخضاعها لنزواته وسلطته، وهذا التأمل في موازين الصراع رافقته رؤية شاعرية انتبهت إلى التاريخ ونبهت إلى مسألة الصراع بين قوى الخير والشر وقيم الحرية وسلوكيات الخضوع، وأوصى بتجنب نفس الخطأ الذي سقط فيه البحر لصالح الاسكندر، لكن دون جدوى. إذ يقول:
غير ما مرة
بل ومنذ أن هبطت ذبابة لأول مرة
هاهنا، في كأس نبيذ
أنا بنفسي
كم
أخطأت
وما من خطإ كان مصدره
غموض المسألة
أو قصر الحياة[18].
حيث يتساقطون تباعا في قبضة أحدهم ولا يتعلمون الحكمة ولا يصغون إلى نصائح الشاعر، فيلقون مصيرا لا يحسدون عليه، خاصة أن هؤلاء كانت فيهم جميع مقومات التحرر من قبضة الخضوع وتحديد مصائرهم، وبناء مستقبلهم، لكنهم يقعون في نفس الخطأ والكمين، حيث يقول:
الخطأ دائما في عمر الزهور
الخطأ مياه عذبة
ولكن،
فوق أرض محروقة[19].
تبدو مظاهر الاستبداد والخضوع في هذه القصيدة واضحة، عند فئة عريضة من الناس، الذين ألفوا ذلك وتعودوا عليه ولم يعد بمقدورهم رسم مسافة من هذا الوضع السيء، الذي يحط من الإنسان ويجرده من إنسانية، ويكرس تلك التبعية العمياء، والانصياع الكامل، لرغبات الاسكندر الذي يرمز لهذا الاستبداد المنتشر في مستعمرته، يحكمها بالحديد والنار، يبالغ في ذلك، يتركها أرضا محروقة.
وفي قصيدة (خسارات لا يفرط فيها) ينهل محمد بنطلحة عباراته من الهامشي والفلسفي والنفسي والتاريخي، ليسمع للعالم أصواتا ملتهبة أخرسها القدر، فتكتمت على ما يعتري النفس ويخالجها من مشاعر جياشة، وأسرار طال مكوثها داخل أجساد ما زالت عاجزة عن البوح، لم تجد في طريقها سوى شاعر أحس بالهم الذي أثقل كاهلها، فاستقصى منبعه، وخط مجاريه بيده، ولملم جروحه وندوبه التي لا يزال بعض أثارها باديا للمشاهد، يقول في مستهل القصيدة:
لا قنب
ولا طالوش
فقط، كدمة زرقاء من يد الخطاط
ظلال بيننا. وحشرة، كالحقيقة الأزلية
بين الشقوق.[20].
هذا البوح الذي ترجمه الشاعر باعتباره لسان حال هؤلاء، فتح بابا رحبا لمشاركة همومهم ومآسيهم التي نفذت بين الشقوق والنتوءات، كما يفعل الماء حينما يعتصر بين الصخور الصلبة، فتشتد صلابته، وكثافته، ويستجمع قوته، حتى ينفجر، كالعاصفة، غير منتبه للمأزق، يأبى القبول بشيء اسمه المستحيل، يترك خلفه الرعب والحقد، والخسارة كذلك، يقول الشاعر في معرض حديثه عن مشاهد هذا الصراع:
وبالحجة، النص من فرشي. مفكك أصلا. فوق الماء.
وليس من حوله أي مركز حدودي. هل أخطأت، حتى هذه المرة؟[21].
لقد استحضر عددا من الرموز التصويرية التي تلائم دفقته الشعورية، وحاله النفسية، عندما وظف وكالات الأخبار في سياق غير مألوف، على اعتبار أنها لم تصل الحدث، وبالتالي ظلت عاجزة على القيام بالدور المناسب لها، وكذلك الجموح الكافكي الذي انزاح على نظرة الالتباس والغموض، ومطاردة الطغاة، لينغمس في تصوير طريقة استعمال المبيدات، للقضاء على الحشرات، بما فيها الفراشات التي لم يعد يألفها الشاعر، وهي تنتشي بالأزهار في طبيعة خصبة، بل تحولت لحاملة طائرة في ساحة حرب نفسي بين الذات وظلها ، في انهيار تام للنص، وحيرة مستحدثة للقارئ الذي يقع ضحية مزج بين الفكر والدين والعلم والثقافة والخيال، فيتيه في مطبات البحث عن فردوس مفقود. يعود الشاعر مرة أخرى فيقول:
إذن، وكالات الأخبار لم تصل إلى مكان الحدث:
بين الشقوق. ناهيك عن أن كافكا تحاشى دائما وهو
يكتب استعمال مبيد الحشرات. حتى الرب، كتب الفردوس
(الطبعة الأولى) ولم يقل: ها هنا آجرة إذا زالت انهار النص
كله. الخطاطون هم الذين زادوا فيه. وكتبوا: كا آجرة،
ها هنا طوطم. أجل، الفردوس فكرة جهنمية. فخم ومرعب.
لذلك ونحن فيه لا نطيقه. في النهاية ما ذنب القارئ؟
سوف يأتي يوم تصبح الفراشة حاملة للطائرات.
آنذاك، من أمازح: غوتنبرغ؟
أم أحد عشر عشر كوكبا؟[22]،
تحمل هذه الكلمات إحالات عن معان ودلالات نفسية تستحضر الاعلام الذي انساق وراء الموضوعات الغثة، وصرف النظر على قضايا الساعة، يقابل ذلك زيغ كافكا اليوم عن مطارة الظلم، والتباسات الواقع والمسخ وحال الرعب وغير من الصور المأساوية التي ، لم يعد أحد يقبله بها، وانصراف الفراشات على رقتها وخفة ظلها إلى صورة جديدة، هذا التحول في المستقبل قد يجعلها، سلاحا ضد طموح الشاعر ومن ينتصر لرأيه، ومناورته للعلم والفكر والدين والثقافة، لم يحسن فعلها، أمام صراعه مع الذات وحاجاتها، فيستسلم لخسارات متتالية، يحتفظ بها على سبيل التجربة واكتساب الخبرة، والعزم والبأس.
- خاتمة:
تترجم تجربة محمد بنطلحة الشعرية مسارات القصيدة المغربية المعاصرة التي رغب أصحابها تحقيق رهانات كبرى تبرز الهوية المغربية في الممارسة الإبداعية وتعلي من شأن القصيدة عبر التحلي بأبعاد رؤيوية وتصورات متبصرة ترفع صوت فئات عريضة من الهامشي والمغيب تنهل مادتها من مشارب ثقافية وفلسفية ودينية متنوعة مفتوحة على قراءات متعددة قصد إنتاج معان ودلالات مختلفة تلج عوالم ظاهرة وخفية تتوخى مقاربة ثقافية للمجتمع عبر رصد بعض القيم والمتغيرات الثقافية والفكرية والسياسية والتاريخية والاجتماعية وتسلط الضوء على التحديات الفكرية التي تعرفها الممارسة الشعرية المغربية المعاصرة.
يختزن ديوان قليلا أكثر للشاعر محمد بنطلحة عددا من القصائد التي تنفتح على مجالات متنوعة سواء الثقافي أو الاجتماعي أو الديني أو الفلسفي تشكل بؤرة تجتمع حولها أسئلة قلقة تبناها الشاعر للبحث عن أجوبة دقيقة عنها عبر ترك مساحة أكثر رحابة لمحاكمة الذات الشاعرة الفردية الحرة المتمردة على المظاهر الكلاسيكية تعلي من صوت الرفض للقيم والمظاهر السائدة عبر تبنيها نظرة ثاقبة للأشياء.
هكذا تمكن الشاعر محمد بنطلحة من خوض مغامرة شعرية، لكنها ليست عبثية وعشوائية بل مدروسة، تخط مسارتها وارهاصاتها، ورهاناتها انطلاقا من التأصيل لحساسية شعرية مغربية معاصرة، منفتحة على الآخر، وتم هذا الانفتاح بطريقة معقلنة، أسعفته في امتلاك رؤيا جديدة تؤسس لهوية مغربية معاصرة أثناء الممارسة الشعرية.
(عبد الرحيم رفيقي: باحث في جامعة السلطان مولاي سليمان – المغرب.)
المصادر
- عبد الله راجع – القصيدة المغربية المعارة بالمغرب: بنية الشهادة والاستشهاد- الجزء الثاني – ط 1، مطبعة النجاح الجديدة، 1988.
- قائمة المراجع:
- محمد بنيس – ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب: مقاربة بنيوية تكوينية، ط 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1985.
- محمد بنطلحة، قليلا أكثر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007.
List Of References :
- Abdellah Rajaa, alqassida almaghribyya almoassira : binyat alshahada walistishhad, aljuz’ althaani, matbaeat alnajah aljadida, t 1, 1988.
- Mohammed Bennis, thahirat alshier almoueasr bialmaghrib : muqaraba binyawia takwinia, almarkaz althaqafi alarabi ,t2, aldaar albayda, 1985.
- Mohammed Bentalha, Diwan « Qalilan Aktahra » Dar AlThaqafa lilnashr waltawziei, t 1 , aldaar albayda, 2007.
الهوامش
[1] – عبد الله راجع – القصيدة المغربية المعارة بالمغرب: بنية الشهادة والاستشهاد- الجزء الثاني – ط 1، مطبعة النجاح الجديدة، 1988، ص32.
[2] – المرجع نفسه، ص12.
[3] محمد بنيس – ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب: مقاربة بنيوية تكوينية، ط 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1985.ص47.
[4] عبد الله راجع، المرجع نفسه، ص.67.
[5] محمد بنيس، المرجع نفسه، ص47
[6] محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: مقاربة بنيوية تكوينية، ص29
[7] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007. ص5
[8] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص9,
.[9] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص10
[10] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص20
[11] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص20
[12] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص21.
.[13] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص21
[14] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص22
[15] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص22-23
[16] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص.86
[17] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص86.
[18] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص89
[19] محمد بنطلحة، قليلا أكثر، ص89
[20] – بنطلحة، محمد، قليلا أكثر، ص90
[21] – بنطلحة، محمد، قليلا أكثر، ص90.
[22] – بنطلحة، محمد، قليلا أكثر، ص90
